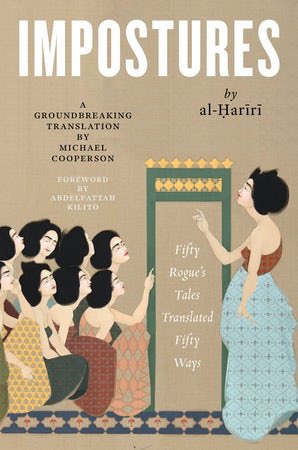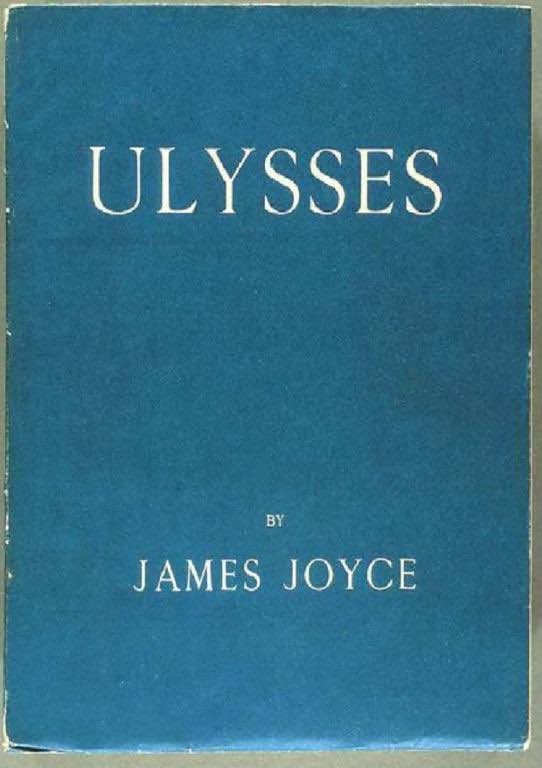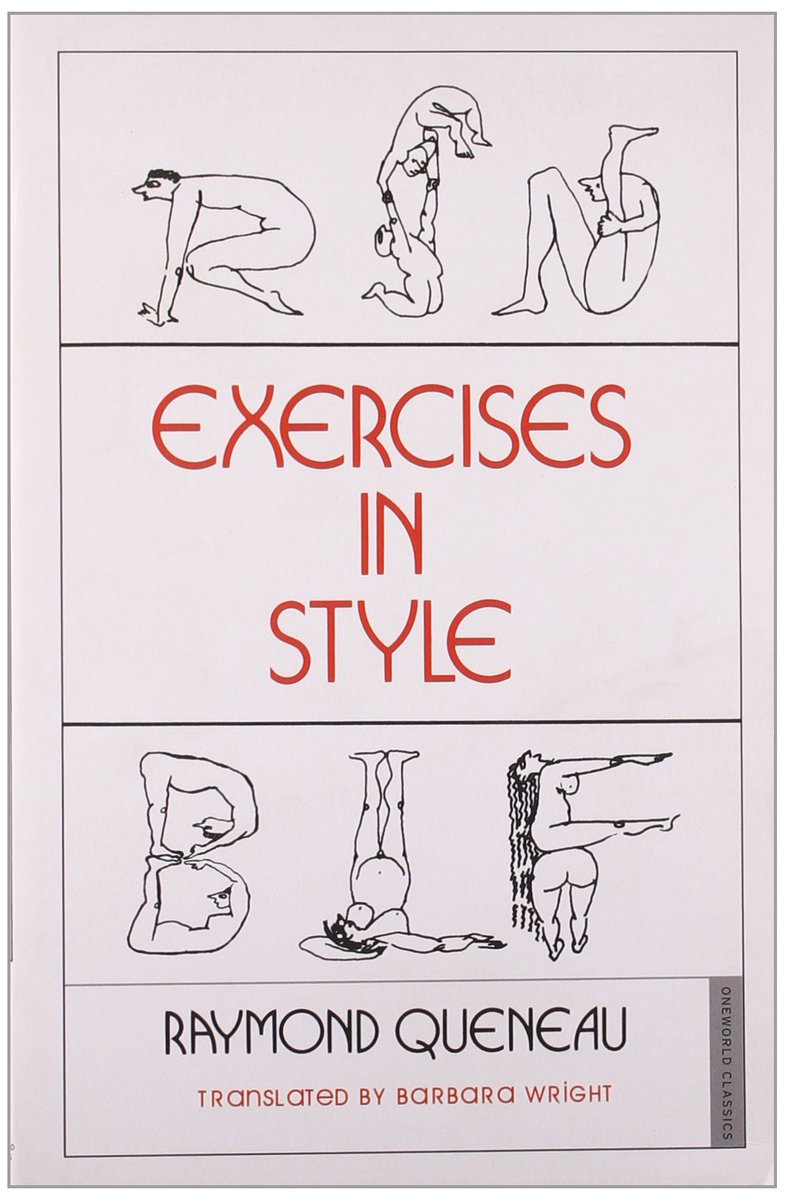اقرأ بمزيج من الحنق والإعجاب ترجمة مايكل كوبرسون Michael Cooperson لمقامات الحريري Impostures ؛ حنق لأني أجدها تمارين أسلوبية أكثر منها ترجمة، وإعجاب لأنه نجح في جعل عمله مهرجانا ينظم معجزات اللغة الإنجليزية تماما كما هي المقامات مهرجان ينظم معجزات اللغة العربية.
يقارب كوبرسون المقامات وهو ممتلئ بالصيت الذائع عنها: ذلك النص العصيّ على الترجمة! يستعرض في مقدمته كل ترجماتها السابقة فيجعلها صنفين: ترجمات حرفية كُتب لها الفشل والاندثار، وترجمات جريئة كُتب لها النجاح والبقاء (كترجمات يهوذا الحريزي وفريدريك روكرت وأنا دولينيا) لذا اختار الجرأة.
يقرر كوبرسون أن يضحي بالسجع منذ البداية. يشرح أنّ الإنجليزية غير قادرة على تأدية الجمل المسجوعة، سيستعمل عوضا عنه تنويع الأساليب، فيترجم مرة على نمط تشوسر، وأخرى على نمط شكسبير، وهكذا. لكنك لا تملك إلا أن تنظر بريبة إلى ترجماته وهي تتكلف الوقوف كمقامة فتصطك ركبتاها: im-posture .
لقد ضحى بأهم ما يميز المقامة: الحركة! لا شيء ينقل لعبة القط والفأر بين الحارث بن همام وأبي زيد السروجي مثل النص المسجوع المكون من جملتين تلاحقان بعضهما، كلما هربت الأولى لحقتها الثانية، فتضطر الأولى إلى استخدام سجعة جديدة، لتعاود الثانية لحاقها، وهكذا في تنويعات لانهائية.
هذا التطابق ما بين المعنى والمبنى، ما بين الحكاية والأسلوب، هو ما يكسب المقامة سحرها ويجعلها أكثر الفنون بهجة وحركة. يُحسب لكوبرسون -على الأقل- أنه لم يهمل هذه السمة كليا، إذ جعل معياره في اختيار الأسلوب مستمدا من قصة كل مقامة، فعندما يتنكر السروجي في زي عجوز يختار أسلوب شكسبير =
ذلك أنّ مسرحيات شكسبير تزدحم برجال في زي نساء، وعندما يهفو قلب قاضٍ لجمال أحد المحتكمين إليه يختار أسلوب تشوسر الذي نقل قصصا مماثلة في حكايات كانتبري عن قضاة تقودهم شهواتهم، وعندما تتناول المقامة رحلة عبر الصحراء يختار لغة الرحالة تشارلز داوتي المشهورة بجمالها ووعورتها، وهكذا.
يؤخذ على كوبرسون أنه كان مسكونًا بتمارين كينو الأسلوبية والفصل الرابع عشر من عوليس Oxen of the Sun أكثر من المقامات! هذا أعطى قارئ ترجمته انطباعا خاطئا يوهم أن المقامات نص يعرض قصةً واحدة بخمسين أسلوبا، بينما الحريري يعرض خمسين قصة بأسلوب واحد.
مأخذي الثالث على الترجمة إخفاقها في نقل عالم المقامات التاريخي والجغرافي. يطوّف بنا الحريري في العواصم والثغور إبّان القرن الخامس الهجري، فيُدخلنا المسجد والخمّارة والمقبرة ويُشهدنا الأعياد ومواكب الحج ومجالس العلم واللهو، مما يجعل المقامة مرآةً تعكس حال العالم الإسلامي آنذاك.
غير أنك تقرأ المقامة الصنعانية مثلا فتخال أنك على ضفاف المسيسيبي -لاستخدامها لغة مارك توين في هكلبري فن- رغم أنها تدور في صنعاء! وتقرأ المقامة البرقعيدية فتخال أنك في أزقة نيويورك الخلفية -لاستخدامها معجم المجرمين الذي صنفه رئيس الشرطة جورج ماتسل- رغم أنها تدور بين سوريا والعراق!
ما سبق ليس قصورًا في الترجمة، وإنما نتيجة طبيعية لقرار استخدام وفرة الأساليب، إذ يأتي كل أسلوب محملًا بمصطلحاته المتعلقة بالمطعم والمشرب والعملة والملابس والشتائم والأمثال، مما يعضد رأي فتجنشتاين ورفاقه: العالم الذي نعيشه لغوي بالضرورة، إذ لا نستطيع مقاربته إلا لغويا.
هذه بعض المآخذ على الترجمة، أما عدا ذلك فيشهد الله أنها من أمتع ما قرأت وأجدره بالثناء والقراءة، لا أنهي مقامةً حتى أبادر إلى التي تتلوها كي أرى أيّ أسلوب اختار ولماذا اختاره. يُحسب للترجمة أنها تطفح ظَرفًا وبهجةً وتجريبًا ومشاغبة، وهذا كله يذكّر بقلم الحريري.
يُحسب أيضا لكوبرسون تمكنه المذهل من الإنجليزية نثرا وشعرا، وقدرته على اطرّاح لسانه وانتحال ألسنة الآخرين، فهو تارة تشوسر، وتارة شكسبير، وتارة بوزويل، وتارة مارك توين، وتارة فيرجينا وولف، وتارة بائع سنغافوري يتحدث السينغليش، تماما كما كان أبو زيد السروجي يظهر بخمسين وجه وهيئة.
نبّه كوبرسون في مقدمته إلى نقطة كانت غائبة عني بخصوص عوالم المقامات واقتصارها على الاحتيال والكدية. عندما تخيّل الحريري أبا زيد السروجي بقدراته اللغوية فوق الطبيعية، كان يعالج طبيعة اللغة بثنائيتها الإلهية-البشرية، خصوصا لغتنا العربية كونها لغة الوحي والقرآن.
بعد انقطاع الوحي، عادت اللغة العربية بشرية مرة أخرى. فكما تستخدم للتعليم والإرشاد والهداية أصبح بالإمكان استخدامها للكذب والغش والخداع والتلبيس والكدية. لكن حتى وهي تُستخدم في الأغراض الدنيئة ما زالت تحتفظ بطبيعتها المضيئة: ذاكرتها أنها في يوم ما كانت صوت اللانهائي والخالد!
يعتذر كوبرسون في مقدمته -وكأنه يترقب اعتراضًا- أنّ عمله وإن لم يكن ترجمة فهو على الأقل Transcultration (نقل نص إلى ثقافة أخرى). أكاد أوافقه، فالترجمة في ذهني نوع من الضيافة، تستضيف نصًا/فكرة داخل بيتك اللغوي، وكما تكرم ضيفك بأعرافك المحلية يستحسن ترجمة النص بأعراف اللغة المضيفة.
مقامات الحريري نص يحتفي باللغة العربية وقدرتها على صنع المعجزات. لا أتخيل طريقة أمثل لنقل هذه الثيمة إلا بجعل الترجمة نصًا آخر يحتفي بقدرات موازية للغة الإنجليزية. أرى أنني بدأت حانقًا وانتهيت موافقًا، وهذه ردة فعلي إزاء أيّ عملٍ يجمع بين التجريب والعبقرية.

 Read on Twitter
Read on Twitter